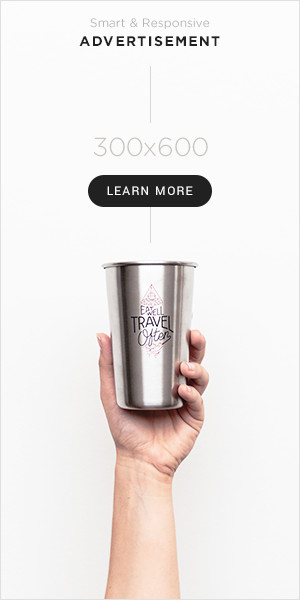كتبت: هبة إسماعيل
في كثير من المجتمعات، يظهر بين الحين والآخر مشهد يستحق التوقف أمامه:
تكون الشريحة الأكثر حضورًا في عمليات التصويت هي الفئات الأبسط اجتماعيًا أو اقتصاديًا، الباحثة عن خدمة أو مساعدة أو وعود بحل مشكلات يومية. هؤلاء لا يجوز أبدًا التقليل من شأنهم، فالقانون منحهم الحق الكامل في التصويت، مثلهم مثل أي مواطن آخر.
لكن الخطورة لا تكمن في مشاركتهم، بل في الطريقة التي يُستغل بها هذا المشهد لترويج فكرة أن «الديمقراطية لا تناسب هذا الشعب»، أو أن الناس «غير ناضجة» أو «جاهلة»، مع استدعاء مشاهد الصراخ والعراك لتبرير الدعوة إلى نموذج أن البعض يقرّر عن الجميع، ويُطلَب من الآخرين فقط أن يصفّقوا ويطيعوا. هنا تتحوّل مخاوف الفوضى إلى بوابة واسعة لاستدعاء الديكتاتورية.
على الجانب الآخر، توجد طبقة واعية ومثقفة وأصحاب خبرات حقيقية يمكن أن تضيف للمشهد العام، لكن في بعض النماذج السياسية والإدارية تُهمَّش هذه الفئات أو تُستبعَد، لأسباب شخصية أو نفسية أو خشية من النقد. ومع الوقت، قد يتولد لديها شعور بالإحباط، يتحول إلى غضب صامت، ثم انسحاب من المجال العام، وفقدان للأمل في أي تغيير حقيقي، فقط لأنهم لم يُعامَلوا كمواطنين شركاء لهم حق السؤال والاعتراض والمشاركة.
بين هذين الطرفين، قد يتطرف المجتمع في اتجاهين:
• فريق يقدّس الديكتاتورية بحجة «الاستقرار»، وينسى أن الاستقرار القائم على القهر هشّ، ينكسر عند أول اهتزاز حقيقي.
• وفريق آخر يطالب بديمقراطية بلا قواعد ولا ضوابط، فتتحول الساحة – في أي مكان يتكرر فيه هذا النموذج – إلى فوضى، وقرارات كارثية، واختيارات لا تعبر عن مصلحة عامة حقيقية.
في مثل هذه النماذج، لا تكون الأزمة في «فكرة الديمقراطية» ذاتها، ولا في «شعار الاستقرار» الذي ترفعه الديكتاتورية، بل في القاعدة التي يُبنى عليها النظام: القانون وطريقة تطبيقه.
فلا ديمقراطية تنجح بلا:
• قانون عادل وواضح ومُعلن،
• وتطبيق حازم لا يفرّق بين قوي وضعيف،
• وشفافية تمكّن المواطن من الفهم قبل الحكم،
. و مساحات حقيقية للمشاركة ، لا تُمنح في يوم التصويت فقط ، بل في صناعة القرار من بدايته
عندما تُبنَى المنظومة على هذه الأسس، تتحول «أنياب الديمقراطية» من فوضى مُحتملة إلى قوة تحمي الحقوق،
وتتحول «إحباطات الديكتاتورية» إلى تجربة تاريخية نتعلم منها… لا نموذج نكرره في كل عصر.